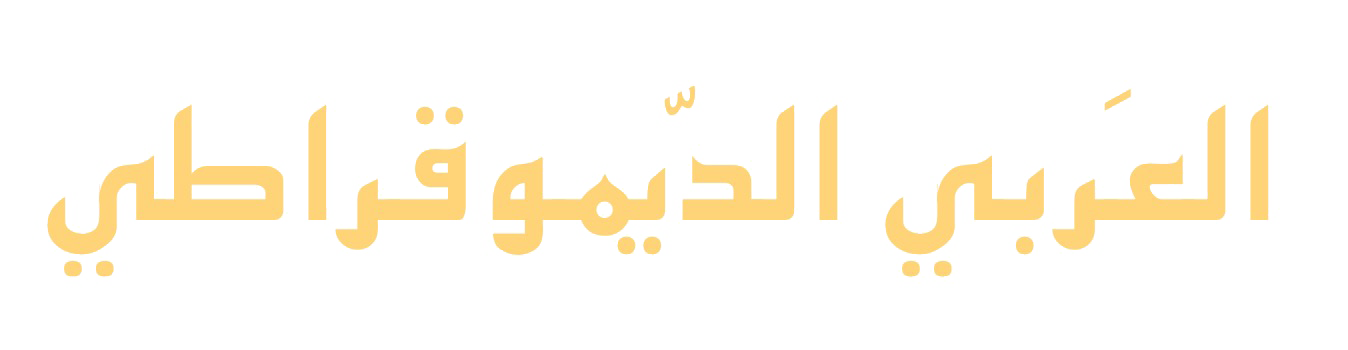عائشة صبري
من المواضيع الشائكة والمثيرة للجدل، التعاطف مع القتلى في سوريا أو الشماتة بهم، ففي هذين الشعورين المتناقضين، تنشب حروبٌ كلاميةٌ وسجالات بين أطراف القضية، وكلّ طرف يرى نفسه المحقّ في شعوره وتوصيفه لضحاياه، ويمكن تقسيم توجهات الرأي حول القضية كالآتي:
الطرف الأول: (المتضرّرون) هم الضحايا وذويهم من أهل الثورة السورية الذين قُتلوا قنصاً، وقصفاً جوّاً وبرّاً، وخنقاً، وحرقاً، وضرباً وسحلاً، وذبحاً بالسكاكين، وبأشنع أنواع التعذيب سجناً، بل جوعاً وبرداً وفي أعماق البحار غرقاً، وبالسكتات القلبية قهراً.. وهُجّروا عُراةً كما تُقلع الأشجار من جذورها.
الطرف الثاني: (مُسبّب الضرر) هم المجرمون؛ من بشار الأسد وجيشه وشبيحته وميليشياته المحلية والدولية، وذويهم الداعمين والمشجّعين لهم تصفيقاً وتهليلاً للتنكيل بالطرف الأول، ولم يتركوا طريقةً إلا وفعلوها في التنكيل تفنُّناً وتلذذاً باستباحة الدماء بلا هوادة.
إنَّ الفوارق كثيرة بين الطرفين، لكن من أبرزها أنَّ الأول يُقتل في منزله غيلةً وحقداً، بينما الثاني يأتي من منطقة أو دولة أخرى قاصداً القتل، فالطبيعي أن تُقابله ردّة فعل مشروعة بحقّ الدفاع عن النفس، فتسلّح المدنيون وانشق العسكريون الرافضون للقتل. ويُمكن تقسيم الطرف الواحد لثلاث فئات: “متشدّد، محايد، متسلّق (منافق)”، لذلك تبدأ الخلافات الداخلية فيما بينهم عند كلّ ظرف أو محنة أو حدث لا سيَّما أحداث المشاهير.
الطرف الثالث: (الحياديون يُعرفون بالرماديين) هم الذين لا يُظهرون موقفاً واضحاً، وهذا ينطبق على المشاهير وأصحاب التأثير على الرأي العام أكثر من عامة الشعب، يقفون على الحياد ينتظرون مَنْ ينتصر، كما ويتباهون بأعمال ومواقف إنسانية، ولا يميّزون بين مجرم محتل وثائر مكافح، ويتذرّعون بأنَّ “سوريا للجميع”، وينجر وراءهم البعض من الطرف الأول، بل ويدافعون عنهم.
تجدهم هامشيين يبحثون عن مصلحتهم الشخصية في أحد الطرفين ليلتحقوا به. لذلك نجد الكثير ممّن التحقوا بصفوف الثورة السورية لا يعرفون مبادئها، ولا يُطبّقون مطالبها، وأهدافها منسيّة بالنسبة إليهم، يكفيهم أنّهم أصبحوا ذوي مراكز مرموقة وأصحاب ثروة يتبروزون بالعلم الأخضر الذي لو نطق لفضح سرائرهم.
لطالما يُثير هؤلاء الجدل باسم الثورة ويُوجّهون رسائل مبطنة، وليس لديهم مانع بمصالحة القاتل والتعزية بقتلاه بحجة الإنسانية وأنَّ الجميع سوريون، ويلقون اللوم فيما حصل على الثوار، إضافة إلى سعيهم لمحاباة الأسد سياسياً بحثاً عن حصة، وإذا ما قصفته إسرائيل يمتعضون باعتبارها تقصف سوريا. وفي كلّ مرّة يسقط فيها قتلى بمناطق النظام يسارعون بالتعزية والتنديد، بينما القتلى بنيران الأسد لا يعطونهم أهمية.
ومؤخراً في حادثة قتلى حفل خريجي الكلية الحربية الذين كان يتم تجهيزهم لإكمال مسيرة سلفهم في قتل الشعب السوري وتشريده، شاهدنا عدداً من المتعاطفين معهم من المحسوبين على الطرف الأول. إنّهم يتباكون على مشاهد الفقد لذوي الضباط، وكأنّهم كانوا في حفل تخرّج من مجال مفيد. هم خريجو ماذا ومَنْ!..هل تناسوا كم أدمت هذه الكلية الحربية من أبناء حمص عندما كانوا محاصرين بنيرانها!.. فيما ذهب أحدهم إلى أنّ تياراً متشدداً في نظام الأسد كان يبحث عن أي ذريعة لقصف إدلب والانقلاب على العملية السياسية. وهل هو دخل في العملية السياسية أصلاً؟
ولم يكتفوا بالتعاطف مع مشاريع القتل، بل وصفوا من ينتقدهم بـ”الثوار الأغبياء”.
أيضاً التذرّع بمقولات لرموز الثورة الأوائل عن المساواة بين السوريين، هو دليل يتخذه هؤلاء لتبرير مواقفهم بحجة المحاربة النبيلة، والأبرز مقولة للشهيد يوسف الجادر أبو فرات: “أنا حزين جداً، لأنَّ هذا العتاد عتادنا، وهذه الدبابات دباباتنا، والذين يموتون إخوتنا، وكلّ هذا بسبب تمسك الأسد السفاح بالكرسي”. كما يستندون دينياً على كراهية الشماتة في الموت، فيخلطون الصالح بالطالح، لكن من وجهة نظري فإنَّ لكلِّ مقامٍ مقالاً ولكلِّ متوفى حالة معينة.
باعتقادي كلام الرموز يُقال بناءً على مواقف معيّنة، فبنية القول لا تنفصل عن سياقها وظرفها الزماني والمكاني، لذلك نستخدم أحياناً مقولات تاريخية قيلت في ظروف وسياقات تتشابه مع الظروف والقيم التي نعيشها. وفي مقولة “أبو فرات” لا يُشير إلى الحزن على جيش الأسد المجرم، لكن المعنى المنطقي من كلامه الذي لا أحد ينكره هو الحزن النبيل على المآل الذي آلت إليه أمور الجيش وعتاده وجنوده بأنَّهم رهينة لآل الأسد فقط، ولو أنَّ الجيش لم يقتل السوريين لما قاتلوه دفاعاً عن أنفسهم، لكن مدّعي المثالية المفرطة يُفسّرون المقولة على مقاس أهوائهم ومصالحهم الشخصية ليتعاطفوا مع المجرمين، كما حدث من قبل في حادثة تفجير حافلة خاصة بجنود الأسد عند جسر الرئيس بالعاصمة دمشق في العام 2021، وفي حرائق القرداحة عام 2020.
وإن شعر الطرف الأول بالشماتة بموت قاتله، فهو يفرح لخلاصه من مجرمين يواصلون القتل والتهجير حتى من ملاذهم الأخير (الشمال السوري)، وقد ورد عن السلف أنَّهم كانوا يفرحون بهلاك الظلمة، مثلما فرح البعض بموت الحجاج بن يوسف الثقفي، رغم الإنجازات الكبيرة التي فعلها في بناء الدولة الأموية، فكيف بمن كانت أكبر إنجازاته إبادة السوريين وهدم الدولة؟، فلا حرج في الشماتة بما يصيب العدو الظالم المفسد من البلايا، وقد نصَّ الفقهاء على جواز الفرح لانقطاع الشرّ والضرر عن الناس.
أعتقد أنَّ معضلة المواقف الأخلاقية التي تحتاج الوقوف عندها هي الوعي بالتفريق بين القتلى، وإدراك أنَّ التعاطف والشماتة مصطلحان واسعان، فمن الطبيعي أن نتعاطف مع أم تبكي ولدها، لكن من غير الطبيعي أن نتعاطف مع أم مجرم في موته خلاصاً لآلاف الأمهات من فقدان أولادهنّ، ومن الطبيعي أن يكون هناك شماتة بموت مجرم، لكن من غير الطبيعي أن نشمت بموت ضحية بريئة!
بعد 12 سنة من الفظائع، ما يزال الطرف الأول ملتزماً بالأخلاق التي جاءت بها التعاليم الدينية ومستمراً بالمطالبة بحقوق الإنسان، فهو لا يشمت بقتل المدنيين الأبرياء في الطرف الآخر ولا يُميّز بينهم طائفياً، ولا يدعو لقتلهم وحرقهم وإبادتهم كما يُجاهر بذلك الطرف الثاني دائماً، بل يسعى إلى إنهاء الموت السوري، وتحذير حاضنة الأسد بأنَّه لا يتوانى عن قتلهم أيضاً، ودعوتم إلى الصحوة على مُسبّب الضرر لهم، فلا رمادية بين حقٍّ وباطلٍ، ولا وسطية بين مجرمٍ وضحيةٍ.