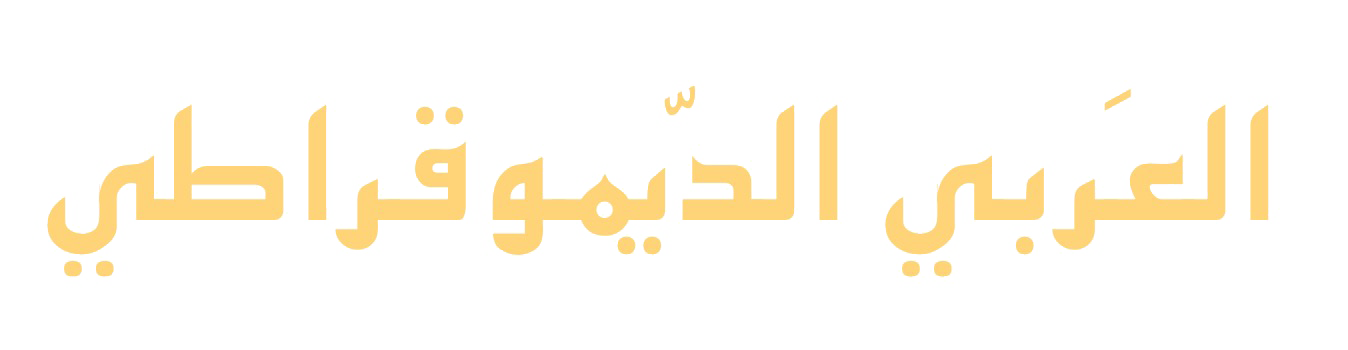انطلقت ثورة السوريين في آذار 2011 وانبثقت من سيرورتها حالتان متصادمتان، جسّدت الحالة الأولى النزوع الثوري بكل سلبياته وإيجابياته، وما تزال تحتل الحيّز الأهم في نفوس شريحة واسعة من جمهور العامة من السوريين، فيما جسّدت الثانية ردّة الفعل الكابحة أو الرادعة للحالة الأولى، وتجد تموضعها الأمثل لدى شريحة أخرى من السوريين يمكن اعتبارها هي الشريحة التي تحوي الساسة الرسميين والقادة المفروضين على الشعب وقسم من الثقافويين إضافة إلى سدنة الإيديولوجيات الكبرى ممّن لا يزالون يعتقدون أن القضية السورية لا تستحق الاهتمام قياساً إلى القضايا الكبرى التي يكافحون من أجلها.
بالطبع حالة التصادم المشار إليها لم تكن تتخذ شكلاً ثابتاً، كما لم تكن تتسم بدرجة واحدة من الوضوح والعلانية، إلّا أن ثمة منعطفات هامة كان لا بدّ أن تعبّر كل حالة عن ماهيتها بكل قوّة، ولعل أبرز تلك المنعطفات سقوط حلب الشرقية بيد قوات الأسد وحلفائه، وما تبع ذلك من تداعيات سياسية أسّست لمسارات كارثية على القضية السورية، ونعني بذلك انطلاقة مسار أستانا الذي أزاح القضية السورية من مركزيتها من حيث الأهمية وجعلها مسألة خادمة لمصالح الدول الراعية الثلاث (روسيا – تركيا – إيران)، وكان هذا الاختراق الأقوى للقرارات الأممية باعتباره أحدث مساراً موازياً يستمد مضمونه من قدرته على تهميش الدور الأممي والالتفاف على ما انتزعه السوريون من حقوق.
وقد أفضى هذا التحول القسري لقضية السوريين إلى انزياحات محلّية مريعة لعل أبرزها ارتهان الكيانات الرسمية للثورة للأطراف الإقليمية وتنصّل تلك الكيانات من صفتها التمثيلية للثورة والتزامها بدور وظيفي لا تملك أيّ هامش للحياد عنه، وكان من تجليات هذا التحوّل تبادل الأدوار وتوزيعها بين أعضاء الائتلاف وقادة الفصائل العسكرية بالتناوب على الحضور تارة في جنيف وأخرى في أستانا وفقاً لإملاءات الراعي الذي بدا ممسكاً برقاب الجميع، وانتهى هذا المنعطف من الناحية العملية بانتصار ميداني كاسح لقوات الأسد تجسّد باستعادة ميدانية لمعظم ما كان خارجاً عن سيطرته، وذلك ضمن إطار اللعبة الروسية الخادعة (مناطق خفض التصعيد)، وبالتوازي فقد أفضى سياسياً إلى قبول هيئة التفاوض بفكرة (السلال الأربعة) التي أثمرت روسياً في مؤتمر (سوتشي أواخر العام 2019 باختزال القضية السورية برمتها في لجنة دستورية ما تزال تتوسّل أمام بشار الأسد لتأخذه الشفقة عليها ويوافق على استئناف لقاءاتها).
لقد أدّى استمراء الكيانات الرسمية لأدوارها الوظيفية إلى حالة مريبة من الإحباط والقنوط لدى الأوساط الثورية على العموم، وقد عزّز من حالة الإحباط تلك أربع سلطات أمر واقع تتقاسم نفوذها في البلاد السورية، وهي على الرغم من اختلاف توجهاتها السياسية ومرجعياتها الإيديولوجية إلّا أن ما يجمع بينها هو نهجها القائم على إذلال المواطن وامتهان كرامته واستباحة أمنه وحقوقه، إلى درجة بات فيها السوريون لا يميلون إلى التمييز بين سلطة وأخرى إلّا بمقدار فارق القسوة والتوحّش، أو بين السيئ والأكثر سوءًا، الأمر الذي أتاح المجال للمتثاقفين الذين حرصوا أن يبقوا محصَّنين داخل أسوارهم ولكن لم يتخلّوا عن نخبويتهم التي تجسّدت بتحوّلها إلى نوع من الدجل ونشر الوعي الزائف بحجة المقاربة الواقعية للأحداث والابتعاد عن الشعبوية، وأصبح ديدنهم الداهم لنفوس الناس هو أن القضية السورية لم تعد بيد السوريين، ولا مناص من انتظار المشيئة الدولية المحكومة بالمصالح، فهي الوحيدة القادرة على تغيير المشهد أو إعادة ترتيبه، بل بلغت ثقافوية هؤلاء إلى درجة ازدراء أي حراك شعبي مجتمعي واتهامه بالسذاجة وقصر النظر.
منذ شهر آب الماضي، وعلى أعقاب إعلان الحكومة التركية توجهها نحو التطبيع مع نظام الأسد، شهدت مناطق الداخل السوري حراكاً شعبياً سلمياً رافضاً لأي شكل من أشكال التعويم لنظام الأسد، وقد رافق ذاك الحراك موجة من الإنعاش الثوري أربكت الائتلاف وملحقاته، وبعد تردّد ولغط كبير في أوساطه المغلقة قام بإصدار بعض التصريحات والمواقف الخجولة علّها تكون مخرجاً لما يراه ورطة كبيرة قد أوقعه فيها جمهور الثورة، ولكن يبدو أن الورطة بدأت تتعزّز وتترك آثارها الفاضحة بانطلاقة الحراك الشعبي بمدينة السويداء منذ الثامن عشر من شهر آب الماضي، وخاصة أن حراك جبل العرب اتخذ طابع (اللاعودة إلى الوراء) وذلك بفضل عدة أمور لعل أبرزها التنظيم والتماسك الاجتماعي بين أبناء المدينة ووحدة المرجعيات فضلاً عن اختيار اللحظة المناسبة لانطلاقة الحراك، أعني حالة التذمر الاجتماعي في عموم البلاد السورية، وعلى الأخص في مناطق سيطرة نظام الأسد من حالة الضنك المعيشي، الأمر الذي حوّل صراع السوريين مع نظام الأسد من حيّزه السياسي المتشرذم إلى فضائه الوجودي الواسع.
ومع انتفاضة السويداء وامتداد المظاهرات إلى درعا والعديد من المدن والبلدات السورية يزداد موقف الكيانات الوظيفية حرجاً وتأزّماً، ولتصبح حالة التصادم المشار إليها في بداية هذه المقالة أمراً حتمياً، فها هي الحالة الثورية المتجسدة في انتفاضة الجنوب السوري والعديد من المظاهرات المتضامنة معها سواء في شمالي وشرقي سوريا أو بلدان اللجوء، وفيما يزداد الحراك الشعبي سخونة ويحظى بتفاعل دولي واضح، وفي الوقت الذي من المفترض فيه أن يكون الحراك السوري الجديد هو محور اهتمام وعمل الكيانات الرسمية والاعتبارية للمعارضة، إلّا أن الأمر بدا مختلفاً، إذ ما يزال الائتلاف تحت غمرة تبديل الرؤساء وتناحرات بين الأعضاء على اقتسام المناصب، بينما هيئة التفاوض وسليلتها اللجنة الدستورية تتوسلان الدول للضغط على الأسد لتفعيل منصة (مسقط) وريثة أستانا، بينما المجلس الإسلامي السوري يلوذ بالصمت، في موقف يوحي بعدم الرضا على ما يجري من حراك لأنه من خارج أقنيته وعباءاته الإيديولوجية.
هي بالفعل لحظة تصادم فاضحة بين حالة ثورية تجذّرت في نفوس السوريين وأثبتت تعاليها وتجاوزها لجميع تخرّصات المرجفين ومصدّري التهم والشكوك، وبين حالة أخرى كابحة، بل عاطبة لأي مبادرة وطنية ومشوِّهة لأي وعي ثوري يثبت عقمها ويفضح زيفها، ولعله من الصحيح أن مواجهة عطب المعارضات الرسمية يمكن أن يكون عامل استنزاف لقوى الحراك الثوري، ولكنها تبدو على أية حال مواجهة حتمية، بل هي جزء من مواجهة نظام الإبادة الأسدي.
الكاتب: حسن النيفي
المصدر: تلفزيون سوريا